ج_ الطباق: وهو نوعان:
طباق السلب، وفيه أدوات نفي: رجعت عمتي من السفر، وما رجعت أختي. تابع أخي دراسته في الجامعة، ولم يتابعها ابن عمي.
وطباق الإيجاب: وليس فيه أدوات نفي: نجح ورسب، الليل والنهار، الاجتهاد والكسل، التعب والراحة... ويكون الطباق في الأسماء، وفي الأفعال (كما لحظنا من الأمثلة) كما يكون في الأحرف (له مثل ما عليه).
د_ المقابلة: وهي طباق مركب، أي كلمتان، تليهما أضدادهما: ليل قصير ونهار طويل. نجح المجتهد ورسب الكسول.
ذ_ الجناس: وهو نوعان: التام، أن تأتي كلمة واحدة بأكثر من معنى: مثال: العين في ضيعتنا أبعد من مرمى العين: العين الأولى هي نبع الماء، والثانية هي أداة البصر. عند الأصيل عدت إلى بيتي الأصيل: الأصيل الأولى هي الوقت بين العصر إلى المغرب، أو هي الوقت قبيل المغرب مباشرة. والأصيل الثانية هي العريق (أي ما جمع بين القِدم والأصالة). ولنأخذ مثالًا آخر، مع بيان قيمته المعنوية: "رأيتُ شخصًا يحتضن طفلتيه، هاتفًا بفرح: آية وآلاء، آية وآلاء من ربنا". آية وآلاء أسماء الطفلات، وآية وآلاء _ بعد ذلك _ بمعنى العلامة المميزة والنِّعَم الكثيرة.
ماذا عن قيمة هذا الجناس؟ إنه يظهر براعة الأديب اللغوية في جمعه الألفاظ المتجانسة (آية وآلاء) وتطويعها للمعنى الذي يريده (تصوير مدى فرح هذا الأب بطفلتيه)، بغية إثارة الدهشة والإعجاب والجناس غير التام: وهو أن تتقارب كلمتان لفظًا، مع اختلاف المعنى: سالت من عينه عَبْرَة لما أدرك العِبْرَة. (عَبرة: دمعة، وعَبْرة: موعظة أو حِكْمَة).
ر_ السجع: وهو توافق نهاية الفواصل: مثال: أشرق النهار، وغنَّت الأطيار. (التوافق بنهاية الراء المضمومة هنا. مثال آخر: الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا قدر عفا. (التوافق بنهاية الفاء المطْلَقَة: فا). والسجع هو علم البلاغة الوحيد الذي لا يُطلَب فيه القيمة المعنوية، بل قيمته واحدة ثابتة، وهي إغناء الكلام بالإيقاع الموسيقي، ويمكن لنا أن نعبِّر عن ذلك بأكثر من صياغة، كأن نقول مثلًا: (يولِّد في النص إيقاعًا موسيقيًا)، أو (يضفي على النص إيقاعًا موسيقيًا عذبًا)، وما إلى تلك التعابير، غير أنني أرى أن قيمته لا تكتمل بهذا التحديد (وهو المطلوب في صف الأساسي التاسع)، ولكن الأفضل أن نكتب القيمة بشكل مفصَّل موسَّع: (يضفي على النص إيقاعًا موسيقيًا عذبًا، ليزيده جمالًا، ويزيد القارئ حماسة وتشويقًا إلى المتابعة).
ز_ الحقيقة: هي أن يدل الكلام على معناه الحقيقي: بنيتُ حائطًا في حديقة داري.
س_ المجاز: (الاستعارة): هو أن يدل الكلام على غير معناه الحقيقي، وندرك مباشرة بالعقل أنه ليس حقيقيًا: استقبلتُ حائطًا في حديقة داري. (المقصود رجل شديد الضخامة، أو شديد العناد).
ش_ التشبيه: إلحاق طرفين بصفة مشتركة بينهما أو أكثر: كأن نقول: أنت كالقمر نورًا: ألحقنا الممدوح بالقمر، لاشتراكهما في صفة الجمال، وليس لاشتراكهما بكل الصفات. أو أن نقول: خالد كالبحر في علمه: ألحقنا خالدًا بالبحر، لاشتراكهما في صفة التوسع والعطاء الذي لا ينقطعان.
ص_ الاستعارة: ونشرحها بالمقارنة مع التشبيه هذه المرة، يجب أن نحذف أحد طرفي التشبيه، ليكون لدينا استعارة، وإلا كانت الجملة تشبيهًا، كأن نقول: (محمود كالبحر في عطائه): المشبه: محمود، المشبه به: البحر. أداة التشبيه: الكاف (وقد تكون مثل أو كأنه أو يشبه أو يماثل...) ووجه الشبه: العطاء. ونحولها إلى استعارة بمحاولة حذف أحد الطرفين، إن أردنا حذف المشبه به (زارني محمود) فالجملة حقيقية ليس فيها استعارة، وبالتالي نستطيع حذف المشبه هنا (محمود) ثم نضع الفعل (زارني البحر في منزلي، قابلتُ البحر في طريقي إلى العمل)... المستعار له: البحر. المستعار منه: الإنسان وهو محذوف. اللفظ المستعار: البحر (لأننا لو قلنا محمود لم يعد لدينا استعارة). الجامع بينهما: العطاء (وقد يكون العِلم، ونحدِّد ذلك من خلال معنى النص العام الذي بين أيدينا). والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي: (الفعل: زارني، قابلتُ).
بنية اللغة العربية بناء وتأثيرًا
[ منتدى اللغة العربية ]
النتائج 1 إلى 20 من 65
الموضوع: بنية اللغة العربية بناء وتأثيرًا
مشاهدة المواضيع
-
31-8-2019 04:48 PM #18


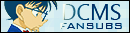
- تاريخ التسجيل
- Jul 2017
- المـشـــاركــات
- 1,308
- الــــدولــــــــة
- لبنان
- الــجـــــنــــــس
- ذكر
الـتـــقـــــيـيــم:









 مجموع الاوسمة: 13
مجموع الاوسمة: 13
 رد: بنية اللغة العربية بناء وتأثيرًا
رد: بنية اللغة العربية بناء وتأثيرًا
Loading...




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات